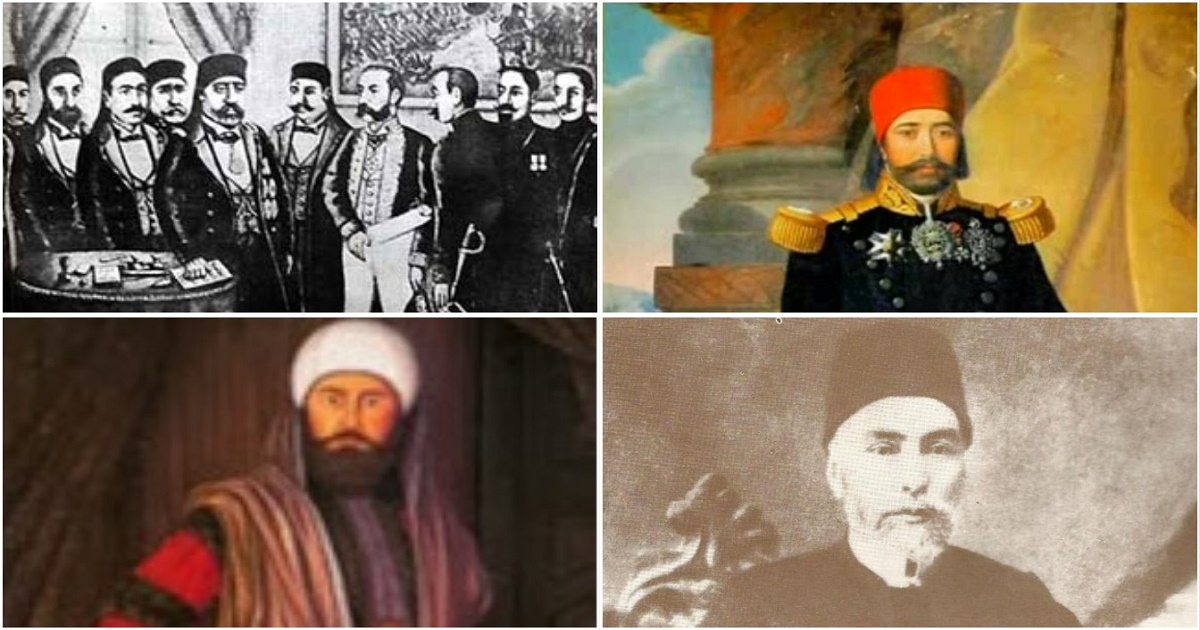
لم يكن الفساد في تونس قبل سنة 1881 انحرافا سلوكيا فرديا لأحد البايات أو اختلالا ظرفيا في أجهزة الدولة الحسينية بل كان من أهم آليات السلطة وأبرز تمظهراتها. ففي ظل سيادة الحكم الفردي المطلق ونمط الدولة الريعية/ الإتاوية التي تتلخص علاقتها بالمجتمع في سياسة جبائية "قهرية"، شكّل الفساد صلب منظومة الحكم الحسيني، مركزيا ومحليا، القاعدة وليس الاستثناء، بل تحوّل إلى مؤسسة بكل ما تحمله الكلمة من معاني الشرعية والتراتبية والاستمرار.
و ربما لم يكن من قبيل المبالغة وصف الدولة التونسية القائمة قبيل 1881 بأنها" ليست سلّم سلطات أو وظائف وإنما سلسلة متعاقبة من الرشاوي" ، يتشابك فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر الفساد المحلي بالفساد الأجنبي بين السرايا والقنصليات الاوروبية التي كان لكل منها موطئ قدم في البلاط الحسيني.
لقد كان الفساد المالي والاجتماعي في تونس، كما وصفه الوزير خير الدين باشا في مذكراته، عاما وشاملا حيث "وقع أفراد الجيش والشرطة، الذين لا يحصلون على مؤنة تسدّ لهم الرمق، ولا رواتب ولا ملابس، في بؤس وقنوط يصعب وصفهما، وخضع معظم الموظفين المدنيين إلى نفس الأوضاع، فصاروا يزايدون على واجباتهم وضمائرهم للحصول على بعض الموارد للرزق، فساد انحطاط الأخلاق في أعلى مستويات الدولة، ووقع بيع الوظائف المربحة، وحتى العدلية لم تعد في مأمن من الفساد العام… وهجر الشعب العمل بقنوط وارتفعت الجرائم بنسب مخيفة" .
وإذا كان الفساد منتشرا في الإيالة و ينخر الدولة والمجتمع في كل المستويات فقد كان "باي تونس"، الذي يغطي بشرعيته على فساد الجماعة وشبكة الولاءات الشخصية والعائلية، من الوزراء والقياد والقضاة واللزامة وشيوخ الزوايا والقائمين على الأوقاف، في قلب العملية التي يختلط فيها الفساد بالاستبداد، باعتباره مركز السلطة و "مالك البلاد".
ورغم التضامن العائلي المعلن داخل البيت الحسيني فإن التوجس والريبة كانا من السمات البارزة في تعامل الباي الحاكم مع إخوته وأبناء عمومته وسائر أقاربه ممن يمكن أن يشكلوا تهديدا لعرشه…ولم يكن من النادر أن يجد بعض أمراء البيت الحسيني أنفسهم في حالة إقامة جبرية…كما كان من "مقتضى السياسة"، بلغة ابن أبي الضياف، أن لا يكون لإخوة الباي الحاكم وأبناء عمومته ثروة زائدة عن الحدّ خشية الخروج عليه لما للمال من قدرة على جمع الجند واستجماع القوة، ولم يكن مسموحا لهم بمخالطة الناس دون علمه.
ولئن اقترن الفساد في تونس قبل سنة 1881 خصوصا بأسماء وزراء، على رأسهم مصطفى خزندار، فإن مسؤولية البايات لا مجال للشك فيها، فنظام الحكم الحسيني كان ميالا ، بدرجات متفاوتة، إلى وزراء فاسدين نهابين للرعايا خادمين لسيدهم، وكانت تلك هي القاعدة التي ينبغي احترامها من كبار أعوان الدولة، إذ لا فائدة من وزير أو قايد لا يقدم شيئا للدولة، المتمحورة حول الباي، ولو اعتصر العباد. ولعل شعار البايات المضمر إزاء ممارسات أعوانهم: "افسدوا كما شئتم فإن خراج فسادكم في النهاية راجع إلينا." و هذا ما تفطن إليه أحمد ابن أبي الضياف حين أشار إلى أن "قوة الأمراء تجعل الأوزار على ظهور الوزراء"، حيث كان البايات يطلقون إلى حين أيدي مساعديهم في مال الدولة المتأتي بالأساس من الجباية ومن سراحات التصدير ومن الإقطاع العقاري فيجمعون ويغنمون ويفتكون ويختلسون ويرتشون ليكون مآل خدمتهم في النهاية المصادرة بيد "باي الكرسي" أو من يخلفه وذلك بذريعة واهية أو من دونها أصلا إلا اقتناص "غنيمة باردة"، وهو ما حدث فعلا مع يوسف صاحب الطابع وشاكير صاحب الطابع ومحمد العربي زروق خزندار ومصطفى خزندار وغيرهم …
ولم يكن أهم الوزراء المتورطين في الفساد مجرد وزراء أو مقربين من البلاط بل كان العديد منهم أيضا منتسبين للعائلة الحسينية عن طريق المصاهرة التي بقيت لفترة طويلة حكرا على المماليك.
وقد وفر التدخل التدريجي للدول الأوروبية في تونس قبيل الحماية، ملاذا آمنا لأعوان الدولة الحسينية الذين أخذوا العبرة من أسلافهم، عبر تهريب "أموالهم" ومنحهم الجنسية والحماية الشخصية، على غرار اللزام محمود بن عياد الذي هرب إلى فرنسا ونسيم شمامة الذي فرّ إلى إيطاليا، بعد أن كان مآل الثروات العقارية والمالية التي يكدسها بعض كبار الأعوان المصادرة مع إعدام أصحابها وملاحقة أتباعهم وأصحابهم بذرائع متعلقة بالتآمر السياسي، وكأن الفساد الجاري للوزراء وأهم أعوان الدولة، بعلم الباي وموافقته، مجرد فساد بالنيابة أو فسادا احتياطيا يدخر الملك الحسيني محصوله النهائي لنفسه أو للمتولي، المتعطش لتجميع الثروات، من بعده، خصوصا وأن الحدود لم تكن واضحة بالمرة بين بيت المال العام والخزانة الخاصة للباي.
ورغم أن القوى الاستعمارية كانت تشجع الفساد والمفسدين في تونس، حتى بعد إنشاء "الكوميسيون المالي" سنة 1869 للتحكم في ميزانية الدولة المفلسة، وكلما شعرت بنوع من الإصلاحات الجدية عمدت إلى تقديم صورة قاتمة عن الوضع وعملت على إزاحة المسؤولين المصلحين )النادرين في الحقيقة)، فإنه لا يمكن إنكار أن تونس، أو دولة البايات، قبل دخول الاستعمار الفرنسي كانت لا تزال "متخلفة" من الناحية القانونية (ندرة التقنين والخلط بين التشريع الديني والتشريع الوضعي) والسياسية (حكم مطلق بيده كل السلطات) والإدارية (غياب أجهزة الرقابة و المحاسبة وقواعد التسيير الحديثة رغم المحاولات الإصلاحية المجهضة) وعاجزة ماليا (حالة إفلاس)، وأن القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع التونسي قبل سنة 1881 كانت أبعد ما يكون عن النزاهة والشفافية واحترام الحقوق والمساواة وكرامة الإنسان والإقبال على العمل…