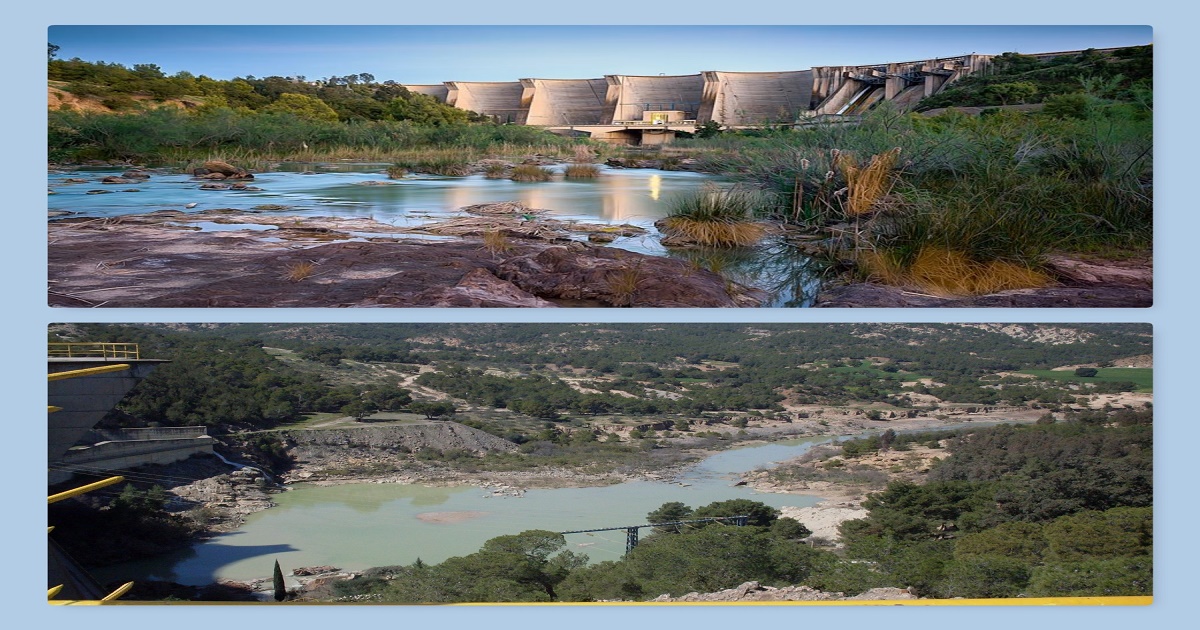
في مثل هذا الوقت من العام، الذي يقترن بالزيت والزيتون، أحب أن أذكر دادة الزهرة رحمها الله، كانت في مثل هذا الوقت من عام 1972 تطفح الزيت في قصعة من الخشب على الضفة الغربية لوادي ملاق الذي نشأت حوله وحواليه، وكانت تنضح الزيت عن سطح الماء في القصعة بتبسي من الفخار الأحمر، وسمك الباربو يأكل بقايا الزيتون من بين أصابعها،
وكنا، نحن أبناؤها بصيغ عائلية مختلفة، نعود إليها من المدرسة "نسيبوا في الثلاثة"، ننطلق جوعى في الثالثة بعد الزوال من المدرسة مثل قطيع من الذئاب الصغيرة، فنجد عندها كسرة القوجة الدافئة وزيت الزيتون الصافي الذي نضحته لحينه من فوق مياه الوادي بحلاب الفخار،
كان يمكن أن أمد يدي بكسرة القوجة في الهواء فتبتل برائحة زيت النضوح الفائحة، الآن أفهم لماذا كانت العصافير وطيور الماء تتحلق حولها، كنا نحن، حين نشبع من الكسرة وذلك الزيت العجيب، نلهو بملاحقة سمك الباربو الذي سلحه الله بغلاف صابوني يستحيل معه إمساكه بأيدي الأطفال،
دادا الزهرة رحمها الله، كانت تأخذنا معها لجني الزيتون، سواء كان عائليا مؤصلا، أو بريا مشذبا من زيتون الزبوز البري، ونحن كنا نراها لعبة طفولة وفضول الاكتشافات وكانت تقول متبرمة كعادتها إن هرجنا أكثر من فائدة ذهابنا معها،
وأنا تعلمت معها استمراء الزيتون الأسود المر الحامض مع الكسرة حتى أصبح أكلتي المفضلة إلى اليوم، إنما كنا نفقد حماسنا لها وهي ترحي الزيتون في رحى القمح وتحمله على ظهر الحمار إلى الوادي كل صباح بين التلال على طريق الوادي والمدرسة، محملة بالقصعة الخشبية وسلة الكسرة الدافئة، وحلاب الفخار وقلة صفراء لجمع زيت النضوح،
لم نكن نعرف وقتها معاصر الزيت أصلا، إما أن نأكله مع الكسرة وإما أن ترحيه دادا الزهرة وتنضح زيته في الوادي، فتتسلى بعبث السمك النهري أصابعها، حتى نأتي نحن بفوضى الطفولة.
بعد أكثر من 47 عاما، أعترف أني لم أذق شيئا أطيب من كسرة القمح الصلب التي تعدها دادا الزهرة وزيتها المنضوح من فوق ماء وادي ملاق، أكتب ذلك وفاء لذكراها، على أمل أن ينفعنا ذلك، أنا علاجا للذكرى وهي عند الله، لأجل القيم الحقيقية،